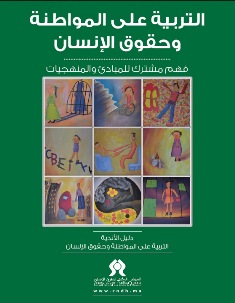دور الأكاديميات والجمعيات العلمية في النهوض بحقوق الإنسان
شارك السيد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في الاجتماع التاسع لشبكة حقوق الإنسان التابعة للأكاديميات والجمعيات العلمية، المنعقد بالرباط في 21 ماي 2009، حول موضوع " دور الأكاديميات والجمعيات العلمية في النهوض بحقوق الإنسان" تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي ما يلي النص الكامل لكلمة السيد حرزني خلال افتتاح هذا اللقاء:

السيدات والسادة،
أود أن أبين في هذه الكلمة الافتتاحية التي منحتموني شرف إلقائها، الروابط القائمة بين العلم والنهوض بحقوق الإنسان، على مستوى الممارسة اليومية والمنهجية وكذا على المستوى الفلسفي.
في مقاربتهما للمصالحة، عملت كل من هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، على تعبئة موارد ومناهج وتقنيات العديد من المجالات العلمية، ابتداء من التاريخ إلى علم الوراثة. هكذا، ومن أجل التأكد من أهلية ضحايا القمع في الماضي للاستفادة من التعويض المادي، فقد تعين الاستماع لهؤلاء الضحايا والتأكد من تصريحاتهم وإجراء التقاطعات بين الشهادات، وفي بعض الأحيان البحث ميدانيا عن شهادات أخرى، مقارنة الشهادات بالوثائق الموجودة، تخزين المعلومات المجمعة ومعالجتها قبل اتخاذ المقررات التحكيمية الملائمة وحساب مبلغ التعويضات.
وقد اقتضى كل ذلك، فضلا عن الاستعادة الضرورية للسياق التاريخي لانتهاكات حقوق الإنسان، اللجوء المكثف لآليات اشتغال ليس علم التاريخ فحسب ولكن أيضا السوسيولوجيا، الأنثروبولوجيا، القانون، الطب، علوم الإعلام والتوثيق، المعلوميات والرياضيات (على الأقل الرياضيات الأساسية). كما تم اللجوء بقوة إلى علم النفس خاصة بمناسبة جلسات الاستماع العمومية إما من أجل مساعدة ضحايا، من بينهم أميون، ما زالوا تحت وقع ذكريات مرعبة لما عانونه في الماضي، لاكتساب ما يكفي من الثقة في النفس من أجل التوجه مباشرة إلى الملايين من مواطنيهم، أو بغية التمكن من التدخل الفوري في حالة وقوع مشكل أثناء جلسات الاستماع.
وبنفس الطريقة، تم اللجوء بشكل يكاد يكون ممنهج للعلوم الاجتماعية في مجال تحديد المناطق التي تستحق الاستفادة من برنامج خاص لجبر الضرر الجماعي، وكذا في تعبئة وتكوين المجتمع المدني للمشاركة في هذا البرنامج وتدبيره وفي عملية تفعيله التي مازالت جارية إلى حدود اليوم.
وفي مجال كشف الحقيقة في حالات الاختفاء القسري، خاصة عندما كان الأمر يتعلق بالكشف عن رفات ضحايا فترة ماضي الانتهاكات المقيتة (الأكثر مقتا على الإطلاق)، فلم يكن لهيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن يتجاوزا خدمات الطب الشرعي والأنثروبولوجيا الجسمانية والتحليل الوراثي.
أخيرا، ومن أجل بلورة مقترحات الإصلاحات الواجب اعتمادها في المنظومة القانونية من أجل ضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان، استند المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة بشكل كبير على مختلف التخصصات القانونية.
يمكننا القول إذن أنه في كل الحالات تقريبا تعاملت هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (والمجلس ما زال يقوم بذلك) مع العلوم تعاملا مكثفا. ورغم أن هذا التعامل قد ركز أساسا على العلوم الاجتماعية (وهو أمر طبيعي إلى حد ما) إلا أنهما تعاملا، ولو بشكل فرعي، مع بعض العلوم الحقة، وهو الأمر الذي يدل على أنه في التجربة المغربية وبلا شك في كل التجارب الأخرى، كان الرابط بين حقوق الإنسان والعلم رابطا جد قوي.
لكن، اسمحوا لي أن أشير إلى أنه إلى حد ما فليس هذا هو المهم، لأنه في نهاية المطاف يمكننا أن نتسائل: أي مجال من مجالات النشاط الإنساني يمكن أن يستغني عن خدمات العلم؟ وأي مجال من مجالات النشاط الإنساني لا يستعمل فيه العلم وأحينا بشكل مفرط؟ إنه يكاد لا يوجد.
أظن إذن أنه من الأجدر أن نبحث، بعيدا عن الروابط الاعتيادية، عن علاقة قرب أكثر دلالة بين العلم وحقوق الإنسان أو أكثر دقة بين العلم والنهوض بالحقوق الإنسانية، على أن تكون علاقة قرب ذات صبغة منهجية.
انطلاقا من كون المنهج العلمي يتضمن أربعة لحظات أساسية قائمة على: وضع المفاهيم للظواهر، أجرأة أبعاد كل مفهوم، وضع الفرضيات والتحقق منها، يمكننا أن نجد كل هذه اللحظات (بدرجات متفاوتة من الوعي والتنظيم) في التجربة المغربية للمصالحة والنهوض بحقوق الإنسان.
لقد تعين، في بادئ الأمر، تحديد ما ذا كنا نعني بالمصالحة: فالانخراط في بحث مهووس عن جلادي الأمس لكشف ومعاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي كان مستبعدا من منطلق المصالحة في حد ذاته. كما أن تحجيم المصالحة في عفو وعناق، وفي أحس الأحوال، وعود بنهج سلوك أحس في المستقبل كان أيضا منطقا مرفوضا من قبل مناضلي الحركة الحقوقية الذين كان في الوقت ذاته مسؤولين عن جمعيات الضحايا.
لقد أبرزوا، استنادا إلى نظرية العدالة الانتقالية، التي كانت قيد التطور حينها، أن المصالحة الفعلية لا يمكن أن تتأتى إلا بتعويض الضحايا على المستوى الفردي و الجماعي ورد الاعتبار لهم وتمكنهم من الحديث في الفضاء العمومي عن معاناتهم، إضافة إلى كشف الحقيقة، بفضل تعاون الجميع، خاصة في حالات الاختفاء القسري، كما أن تلك المصالحة لا تستقيم إلا بإدخال جملة من الإصلاحات، خاصة على الجهاز القضائي لجعله أكثر استقلالية، وفي مجال الحكامة الأمنية لملاءمتها مع المعايير الدولية.
بعد ذلك حدد رواد التجربة المغربية للمصالحة والنهوض بحقوق الإنسان بطريقة منصفة وعلمية أبعاد مفهوم المصالحة. وتمت بعد ذلك أجرأة كل واحد من هذه الأبعاد بشكل يمكن من وضع معايير ومباشرة التنفيذ.
كانت الفرضية الأساسية تقوم على أنه إذا تم الاحتفاظ بكل أبعاد المصالحة وتم تنفيذها بالشكل الصحيح، فلن تترتب عنها مصالحة فعلية فحسب وإنما سيتوسع ويتعمق ويتعزز بذلك مسلسل دمقرطة البلاد رغم ما توجد عليه حاليا القوى الديمقراطية من ضعف، وتشتت وضياع للوجهة.
لقد تم إخضاع هذه الفرضية للتجربة بالشكل الكافي، وأظن أن النتائج كانت أكثر من مشجعة. وتجدر الإشارة إلى أنه عهد بإخضاع الفرضية للتجربة إلى ضحايا سابقين وهو ما يشكل في حد ذاته دليلا، إن لم نقل على حياد فعلى الأقل على صدق نية الحكام، ودليلا على الدمقرطة. كما أن الضحايا، انخرطوا، أفرادا وجماعات، في مسلسل المصالحة. لقد عبروا ولازالوا يفعلون بحرية أمام الرأي العام، وتم كشف الحقيقة في أغلب الحالات، ومن المرتقب القيام بإصلاح عميق للعدالة, كما أن حرية ونزاهة الانتخابات لم تعد موضوع تنديد، وأضحت الحريات الأساسية محترمة، وسيرى فضاء للحوار الاجتماعي النور قريبا، وتم القيام بإصلاحات مجتمعية كبرى من قبيل مدونة الأسرة وإعادة الاعتبار للثقافة الأمازيغية كل ذلك، بالإضافة إلى العديد من الإصلاحات الأخرى التي لا يتسع الوقت لسردها، سيتم بالتأكيد تكريسه وتتوجيه بإصلاح دستوري.
كما هو الشأن بالنسبة لأي مجال علمي، لا يمكننا القول أنه تم بلوغ النتائج المتوخاة بنسبة 100 في المائة. فقد اصدمنا بشكل خاص بنقص التعاون من لدن بعض الأطراف المعنية من أجل الكشف عن الحقائق المتعلقة ببعض الأحداث التي وقعت بعيد الاستقلال. لكن، هذا لا يمنعنا من السعي نحو إلقاء الضوء على هذه الأحداث، إذ سيطلق المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في هذا الاتجاه، بمساعدة الاتحاد الأوروبي برنامجا للبحث في التاريخ الراهن للمغرب.
لست هنا بصدد تمجيد التجربة المغربية في مجال المصالحة والنهوض بحقوق الإنسان، وإنما أحاول فقط إبراز كيف أنه في حمئة هذا العمل، ورغم أو ربما بفضل هذا الخضم، استقر الأمر بهذه التجربة، بوعي وبشكل ممنهج، إلى الخضوع إلى مجال قريب من مجال المنهج العلمي.
وإذا كانت هذه التجربة قد تمكنت على العموم من النجاح في مهمتها فلأن النشاط العلمي والنهوض بحقوق الإنسان يخضعان في الواقع لنفس القيم الأخلاقية: الصرامة والتواضع.
إن النهوض بحقوق الإنسان، شأنه شأن النشاط العلمي، لايسمح بغموض المفاهيم، والديماغوجية، أو أن يستغل من طرف أي قوة، كيفما كانت، أو أي قيمة خارجة عنه.
ومثل النشاط العلمي (كما يجب أن يكون عليه) فإن النهوض بحقوق الإنسان لا يدعي العصمة من الخطأ، بل بالعكس، إنه يؤكد، وهو نتاج عمل بشر يعملون لما فيه خير وصلاح بشر آخرون، قابلية عمله للوقوع في الخطأ، ومجانبة الصواب ونسبية الأداء، علما أنه في كل حال فإن حقوق الإنسان دائمة التجدد وليس لها نهاية، لذلك فإن الفاعلين فيها، شأنهم شأن العاملين في المجال العلمي، ملتزمون دائما بمراجعة أعمالهم.
تكلمت عن "العمل لما فيه خير البشرية". إنها الكلمة الفصل وتستحق التوقف عندها. ففضلا عن التعاون الذي يقوم بين النشاط العلمي والنهوض بحقوق الإنسان من جهة، أو ما يجمع بينهما من قيم أخلاقية، فإن ما يجمع بشكل وثيق بين هاذين المجالين هو مشاركتهما في المشروع ذاته ألا وهو العمل لما في خير البشرية أي المشروع الإنسي، لكن عن أي إنسية (Humanisme) نتحدث؟
ثمة النزعة الإنسية، المقبلة على الإنجاز والمؤمنة بالإنسان، المراهنه على قدرات العقل الإنساني والمسلمة، ضمنا أوجهرا، بتفوق بعض فئات البشر على الأخرى، والتي سعت إلى التحكم كليا في الطبيعة وتجاوز الطبيعة الإنسانية. هذه النزعة الإنسية العنصرية، بالضرورة، مكنت أصحابها من إنجاز إنجازات عظيمة سواء في مجالات العلم والتكنولوجيا أو مجالات حقوق الإنسان. لكنها أسفرت أيضا عن الاستعمار، والحروب والتفاوتات على المستوى العالمي. وحين اعتقد أصحاب هذه النزعة أنهم بلغوا الهدف، حتى صاروا يعتقدون أنهم تجاوزوا مصاف "البشر العاديين"، اصطدموا بحدود هذا التوجه. إذ تبين أن الطبيعة ليست مطاوعة وجامدة بالدرجة التي كانوا يعتقدون. وظهر أن التحكم في المسارات العلمية لا يعني التحكم في انعكاساتها. فالاحتباس الحراري وظهور أوبئة لا عهد للبشرية بها تعد تمظهرات صارخة ومرعبة لهذا الفجوة الكبرى الموجودة بين الأمرين.
من جهة أخرى، أصبح ظاهرا أن أنماط الإنتاج والاستهلاك التي تتبناها الأمم التي توصف بالأكثر تقدما أنماط، بكل بساطة، لا تطاق بل وغير قابلة للتعميم، وذلك في وقت تطالب فيه كل البشرية بنفس الحقوق لكل البشر.
لا أدعي نبوءة ما، ولكن من الواضح أننا تشهد إفلاسا للنزعة الإنسية المذكورة آنفا. لقد حان الوقت إذن للاصطفاف وراء إنسية أكثر تواضعا، أكثر بساطة وأكثر أخوية. إنسية ذات وجه إنساني، والتي كانت في الواقع دائما موجودة، لكن حجبتها، منذ بضعة قرون، النزعة الإنسية الأخرى، الإنسية الطاغية والمتحكمة.
لا ننكر هنا قدرات الإنسان ولا يتعلق الأمر بالتراجع أمام الطبيعة ولا العدول عن سعادة ورفاهية البشر، كل البشر، إلا أنه لا يمكن انتزاع، لا حقوق الإنسان ولا المعرفة، من قوة خارجية. فلماذا اللجوء إلى قوة خارجية في حين أن الأمر لا يتعلق إلا بتحقيق إمكان يستبطنه كل إنسان.
أعتقد أن القضية المشتركة التي يجب أن تدافع عليها العلوم والنهوض بحقوق الإنسان، هي مساعدة كل إنسان على تحقيق إنسانيته بأفضل شكل ممكن، وهو أمر ضامن لنجاحهما.
في سنة 2000 اعتقدنا في المغرب، للحظة معينة، أننا سنصبح بلدا منتجا للبترول. وقد أعلن جلالة الملك ذلك بنفسه في خطاب بتاريخ 20 غشت. إن ما قاله جلالته بخصوص هذه الثروة ينطبق تماما في نظري على موضوع علاقة العلم بحقوق الإنسان. إذ قال جلالته في هذا الصدد " ... فاننا نشدد على أن هذه المنة التي وهبنا اياها الله ستقوي ايماننا وانسانيتنا وستمدنا بطاقة جديدة للجد والاجتهاد والابتكار والمثابرة ونكران الذات والتعاضد والتكافل وغيرها من القيم الحضارية للاستقامة والصلاح والتربية وحسن الخلق والتشبث العميق بالهوية والثوابت والمقدسات والانفتاح الواسع على حضارة العصر والاعتدال والتسامح".
شكرا لحسن متابعتكم